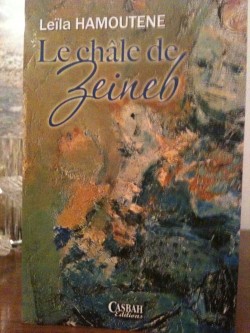“وشاح زينب” والاستعمار الفرنسي في الجزائر
أثناء الحملة الإفريقية، قال الكولونيل فوري بخصوص أحدّ القرى الجزائرية: “… هنا لا وجود للأكواخ المعزولة بل قرى شبيهة بتلك المتواجدة في فرنسا وسط مناطق رائعة، تحيطها بساتين عديدة وغابات شاسعة تملؤها أشجار الزّيتون… جميعنا كان مذهولا بتلك المناظر الخلاّبة والطّبيعة الجميلة، لكنّ الأوامر كانت الأوامر، وأعتقد أنّي أديت واجبي على أحسن وجه: كان علينا تدمير كلّ شيء، تخريب القرية بكاملها، لا نترك فيها لا شجرة مثمرة ولا حقلا مزروعا…”.
تفتتح رواية “وشاح زينب” (Le châle de Zeineb)للكاتبة الجزائرية ليلى حموتن بمشهد مُرَوّع: قرية زينب، بطلة القصّة، تحترق، لقد قام جنود فرنسيون بالهجوم على هذه القرية تحت أوامر تلقوها من قبل مسؤوليهم، القارئ يلتقي مع الفتاة زينب وهي تفرّ مع والدتها وأخيها الرّضيع بعيدا من بطش الجنود الفرنسيين وكذلك من ألسنة النّيران التّي أتت على كلّ شيء أمامها والتهمته. في السّابعة من عمرها، زينب التّي تنحدر من قبيلة بني سالم، تأخذ بيدّ القارئ لتروي عليه قصّتها.
تدور أحداث القصّة خلال القرن التّاسع عشر، سنوات قليلة بعد دخول القوّات الفرنسية إلى الجزائر عبر شواطئ سيدي فرج عام 1840 وهو العام الذّي خربّت فيها قرية بنو سالم. وجهة الفرار كانت اللّجوء إلى أعالي الجبال، لكنّ الثّلاثة كانوا محصورين ومختبئين بين الأشواك لساعات حتّى لا يعثر عليهم الجنود. تقول زينب أنّ والدها التحق برجال القرية وهبّوا ليدافعوا عن شرفهم وعن القبيلة وإبعاد الجنود الفرنسيين عنها ليتمكّن القرويون من الفرار واللّحاق بالجبال.
قرية بنو سالم أصبحت شبيهة بفرن كبير، كلّ شيء فيه يلتهب تقول زينب: “حطب الأكواخ كان يتحطّم، أحيانا كنا نشاهد ألسنة النّيران ترتفع ونسمع في الوقت ذاته صراخ الحيوانات التّي لم تستطع الفرار من هذا اللّهيب. لا أفهم لقد حاولنا تحرير هذه الحيوانات قبل وصول الجنود إلى الحوش… (…) أمّا الآن فعلينا الفرار بعيدًا وعاليًا، الفرار إلى قمّة الجبل، لم أستطع التّنفس (…) خلال سيرنا وجدنا أنفسنا أمام جثث بعض رجال من القرية تركوا مرميين في الحقول، البعض منهم بترت أذناه، والبعض الآخر فصلت رقبته، المنازل والحيوانات والحقول أتت عليها النّيران، إنّه مشهد مروّع، غير بعيد فتيات تمّ سبيهنّ واغتصابهنّ وتركن مرميات، وجدناهنّ في حالة مرثية يعزّ على النّفس وصفها. لقد تمكّنت الحرب من الوصول إلى قريتنا، لم تترك لنا إلاّ البشاعة والنّواح والدّموع، لقد أخذنا نصيبنا من الحداد والأحزان. (…) في ذلك الصّمت المروّع، كنّا نسمع الجنود الفرنسيون يضحكون ويقهقهون بأصوات عالية أو يتضاربون على الغنائم التّي سلبوها قبل حرق المنازل”.
في تلك الجبال الوعرة التي لجأ إليها باقي القرويين النّاجين من المحرقة مع زينب وعائلتها الصّغيرة يحاولون استعادة حياتهم العادية بين قساوة البرد وندرة الغذاء. لكنّ لم تمرّ إلاّ أيام قلائل حتّى عثر عليهم الجنود الفرنسيون، الكابوس لم ينتهي بعد لا لزينب ولا لباقي أهل القرية النّاجين، طلقات الرّصاص بدأت تسمع من بعيد، يعمّ الهلع، ويأخذ الجميع في الهروب من كلّ وجهة والاحتماء داخل كهف.
“أنا أرتشع من البرد والخوف ومن الجوع أيضا، أريد أن أصدّق شيئا واحدا أن يختفي هذا الكابوس وأستعيد سكوني، كفى دموعًا، كفى أمواتًا”.
ومن فصل لآخر، تنتقل بنا الكاتبة من عصر لآخر ومن قرن لآخر، تاركة خيطًا واحدًا يقتفي تسلسل مجرى أحداث تتجسّد في شخصية زينب وبالتّحديد “وشاحها”. ومن خلال القصّة يستوعب القارئ أنّ زينب هي “الجدّة” لجيل من نساء أسرتها أتت بعدها، وتظهر شخصية نسائية أخرى في القصة وهي “وردة” أحد حفيدات “زينب” إلاّ أنّها تظهر في عصر آخر، إبان حرب التّحرير عام 1959، أيّ تقريبا بعد مرور قرن واحد بعد محرقة قرية بني سالم.
لقاء القارئ مع الحفيدة لن يكون بالحدث المفرح بل يعثر عليها ملقاة في أحد الزّنزات تقاسي أشدّ ويلات العذاب من قبل الجنود الفرنسيين، وهي تعاني آلام شديدة في جسدها الفتيّ، تأخذ وردة في الهذيان وتروي على القارئ كيف تمّ اغتصابها بوحشية أوّلا بأداة ثمّ من قبل جنود، اغتصاب يعجز اللّسان عن وصفه.
“لحدّ هذه اللّحظة لم يكن لأيّ رجل ليراني عارية الجسد، لم يمسّني أيّ رجل من قبل، لا أحد مسّني مثلما فعل بي معذّبي. جميع حركاته القذرة تعمّها العفونة. خلع قميصي الذّي كنت أرتديه، أخذ يمسّ ثديايا بلطافة ثمّ بوحشية حيوانية، كان يقوم بذلك وهو ينظر إليّ نظرة الحاقد الشّامت، نظرته كانت مرعبة. (…) كان يظنّ أنّه سينال من جسدي، أن يقضي على أنوثتي، أن يطعنني في كرامتي (…) قاموا بشقّ رجلايا، وأخذوا خيطا كهربائيا وأولجوه في فرجي. وكان الألم. كان شديدًا، كان محرقًا، كان موجعًا (…) صرخت عاليًا وبشدّة ثمّ أغميّ عليّ. (…) عنائي لا يمكن وصفه لكنّه بدا يزول تدريجيًا، أحسّ بسائل ساخن بين فخذاي (…)، إنّه دمّ. دمّ عذريتي، وهي طريقة مثل أخرى لفقدان العذرية. (…) بعد سويعات قلائل أي بعد اغتصابي رموني في هذه الزنزانة استفقت، دخل جندي فرنسي شابّ ومدّ إليّ قطعًا من الشكولاطة متمتمًا “أنت بسنّ أختي”، أردت رفض الشكولاطة، لكنّ الخيبة والحزن الذّي رأيتهما في عينيه غيرا من موقفي وقبلتُ الشكولاطة، يخرج الجنديّ”.
تعود الكاتبة بنا إلى الكهف حيث يختبئ باقي القرويين، لقد لحقوا بهم الجنود ولا مجال من الفرار، أخذوا في إطلاق الرّصاص، إنّها المجزرة. مرّ زمن قليل من ذهاب الفرنسيين، الجميع مات ما عدا أربعة أشخاص: زينب، مريم صديقتها، محيّ الدّين وهو أحد أبناء عمّها ويامنة عمّتها، وقبل الرّحيل من الكهف أخذ كلّ واحد منهم الاحتفاظ بشيء عزيز من أقاربائهم قبل أن يتركوهم جثثًا هامدة، وكان لزينب أن وجدت عند جثة والدتها عقدًا ووشاحًا كانت تحتفظ به في وسطها.
تخرج زينب من الكهف بعد أن تلقي نظرة أخيرة فيه: “أنا يتيمة، لقد أصبحت يتيمة، يتيمة الوالدين، يتيمة قريتي، يتيمة حياتي”.
ومن خلال قرنين مختلفين وفي شخصيتين مختلفتين لا تربطهما إلاّ أواصر الدّم والتربة، تروي الكاتبة ليلى حموتن معاناة كلّ واحدة منهما، من بشاعة الاستعمار الفرنسي، ومن المجازر ومن سياسة الأرض المحروقة التّي عاشتها زينب ومن التعذيبات والاغتصابات والذّل الذّي ذاقته وردة، هل تتمكّن كلّ واحدة من الشّخصيتين التّخلص من هذا الكابوس المريع؟ الجواب يكمن ربّما في شيء واحد هو… “الوشاح”.
“وشاح زينب” للكاتبة الجزائرية ليلى حموتن، صدرته دار نشر القصبة الجزائرية باللّغة الفرنسية… وسيكون قريبًا في الأكشاك.